صدى الشعب – لقد أوقع العالم الرقمي الإنسان في قيم الزيف والوهم والكذب، واستخدم تقنيات كثيرة مثل تقنية “التزييف العميق” (Deepfake) لقلب حقائق الواقع حتى يصبح الكذب صدقا والوهم حقا، إلى درجة استحالة التمييز بين الواقع المطبوع والواقع المصنوع، وفي هذا انقلاب للقيم ما بعده انقلاب، هذه التقنيات تتحدى الواقع لتصنع واقعا لها، متوسلة بكل معطيات الواقع الطبيعي والحقيقي من أجل صناعة واقعها.
وإذا كان من الاشتقاق أن الإنسان سمي كذلك لأنه يأنس بغيره فإن الأنس لا يتحقق دون نسيان هفوات بعضنا تغاضيا وتجاوزا وتسامحا، إذ لولا هذا النسيان لما استقرت علاقة ولا بالأولى توثقت صلة، سواء كانت في الأسرة أو في الصداقة أو في غيرهما من العلاقات والصلات التي تطوي داخلها كل القيم التي يقوم بها الإنسان.
إن عدم نسيان الآلة الرقمية كل المعلومات المسجلة فيها ضرب لقيمة النسيان التي تميز الإنسان في معاملاته، إذ إن النسيان قد يكون وسيلة للتسامح واستئناف علاقات جديدة تبني ولا تهدم وترفع ولا تضع، فيما عدم نسيان الأحقاد والعورات ليس إلا وسيلة للتصارع والتقاتل.
ولا ينفع هنا اعتراض المعترض بأن عدم النسيان قد يكون توثيقا للخير، وبالتالي مجاوزة الصراع السابق، ذلك أن عدم نسيان الخير رتبة خلقية لا يوصل إليها الفعل الآلي، إذ إن الأصل في من لم يحصل هذه الرتبة هو نسيان ذلك الخير أصلا أو تناسيه عمدا خدمة لمصلحته المادية وتحقيقا لمنفعته الحسية.
ومعلوم أن تذكر المعروف وعدم نسيان الجميل قيمة عليا لا تدرك الآلة معانيها الخفية ولا أخلاقها السنية، حتى وإن حفظت ظاهرها وصورتها، هذا فضلا عما أكسبته الآلة للإنسان في الزمن الرقمي من أوصافها الإجرائية والتقنية حتى فصلته عن عمقه القيمي بكل ما فيه من معانٍ سامية وتذوقات راقية.
هذا، زيادة على أن النسيان في سياق بناء الأخلاق وتوثيق العلاقات هو كمال للإنسان وليس إنقاصا له، كما كان كمالا للتعريف في أصل الاشتقاق الذي يعتبر الإنسان إنسانا لأنه ينسى.
وإذا كان من الاشتقاق أن الإنسان سمي كذلك لأنه يأنس بغيره فإن الأنس لا يتحقق دون نسيان هفوات بعضنا تغاضيا وتجاوزا وتسامحا، إذ لولا هذا النسيان لما استقرت علاقة ولا بالأولى توثقت صلة، سواء كانت في الأسرة أو في الصداقة أو في غيرهما من العلاقات والصلات التي تطوي داخلها كل القيم التي يقوم بها الإنسان.
ولنا في الخزان التداولي الإنساني ما يزكي هذا، إذ نجد عبارات ومسكوكات مثل “نحن أبناء اليوم”، و”ما فات مات”، و”الإسلام يَجُبُّ ما قبله” تدعم النسيان الذي يحقق به الإنسان كماله، لا النسيان الذي يكرس به هلاكه، من قبيل النسيان الذي أهبط بني آدم قيميا قبل أن يخرجهم من الجنة وينزلهم إلى الأرض.
كل هذا الانبهار والتحير جعله يقترن بوصف الرقمية اقتران ازدواج، بحيث أصبح يرجو أن يفعل كما تفعل الآلة الرقمية في أفعالها الإجرائية وحركاتها التقنية حتى تجرد من إنسانيته وخرج عن طبعه، ساقطا في درك الآلية، ومعلوم أنه لا مُخرِج للبشر من حقيقتهم من دخول فعل الآلة على سلوكهم وتصرفاتهم.
إن العالم الرقمي حرم الإنسان من حقه في الارتقاء الوجداني والسمو الخلقي، إذ إنه حصره في منظومة من الإجراءات التي تتميز بها الآلة صورة وضوءا وشبكة وغيرها من المميزات الآلية التي تتسم بالجمود، لخلوها من المعاني التي تعطي الأفعال دلالتها الخلقية.
هكذا تساهم الرقميات في تقزيم دلالة حياة الإنسان، إذ تقصرها على الدلالة المادية، مضيعة بذلك ما في الحياة من دلالات روحية تحقق للإنسان سموه وكماله وعلوه بشكل لا تحققه الدلالة المادية المحدودة.
إن انبهار الإنسان بفتوحات العالم الرقمي وإنجازاته التي لم يشهدها التاريخ من قبل جعلته يدخل في غيبوبة جمدته على واقعه، بحيث فقد معها القدرة على تحسس كل جوانب زمنه فضلا عن استشراف مستقبله، فأضحى جامدا في محله غير قادر على الحركة ليرى موقعه داخل الكون.
كل هذا الانبهار والتحير جعله يقترن بوصف الرقمية اقتران ازدواج، بحيث أصبح يرجو أن يفعل كما تفعل الآلة الرقمية في أفعالها الإجرائية وحركاتها التقنية حتى تجرد من إنسانيته وخرج عن طبعه ساقطا في درك الآلية، ومعلوم أنه لا مُخرِج للبشر من حقيقتهم من دخول فعل الآلة على سلوكهم وتصرفاتهم.
وبذلك ينتفي كل معنى للقيم، إذ يصبح فعل التضحية مثلا بلا معنى، لأنه ليس إجراء ولا تقنية، فضلا عن غياب كل مكسب مادي من ورائه، فالزمن الرقمي لا يرسخ في الكائنات ربحا أعظم من الربح المادي، بحيث يصبح الربح المعنوي بلا قيمة ولا مضمون.
وهكذا، يكون الإنسان قد تنازل عن روحه التي ترتقي به إلى أعلى مراتب إنسانيته، كما يكون قد تخلى عن شعوره الذي يسمو به إلى أزكى معاني حياته.
لقد جعل الزمن الرقمي البشر مجرد كائنات تنفيذية بمعزل عن أهم مميزين للإنسان، وهما الحرية والاختيار، فالكينونة التنفيذية التي ألبسه إياها هذا الزمن جعلته خاضعا للبرمجة مثله مثل الأجهزة المصنوعة، وما دام قد برمج يكون قد خرج من طوره الإنساني المميز بالحرية إلى طوره الرقمي المميز بالحتمية، وبذلك يصبح كائنا تنفيذيا ينفذ ما شاءه منه مبرمجه وفق توليفة معينة تكون أشبه بما تفعله الخوارزميات في البرامج الحاسوبية.
وإضافة إلى ما سبق، فإن من الانقلابات الجوهرية التي أحدثها الزمن الرقمي في الإنسان عدم اكتفائه باقتحام فضائه العام، إذ صار إلى اقتحام فضائه الخاص أكثر إصرارا، وذلك عن طريق استدراجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي و”الميتافيرس” إلى فضح كل خصوصياته وحميمياته جلبا لأكبر عدد من المشاهدات والتعليقات والاستيطان في الإنترنت بواسطة “الأفاتارات”، وبالتالي طمعا في أكبر قدر من الأرباح والعائدات.
وبناء على ما ذكر يكون الإنسان قد انتقل من طور الطي والستر إلى طور الفضح والنشر، بحيث يتعذر عليه في حال ندمه -وهذا شعور إنساني نبيل- أن يستأنف حياته بطريقة عادية، لكونه بات كائنا مفضوحا تلاحقه فضائحه أينما سار وذهب، وتُذكّره ذاكرات الرقميات بما كان يفتخر به وصار إلى التواري منه حين استرجع عمقه الإنساني، ولات حين مندم.
ذلك بأن التواري خرج عن ملكه لكونه تنازل عن حقه في امتلاك خصوصياته متى ملَّكها غيره من الناظرين والمتابعين، ونتيجة لذلك يفقد حتى حقه في طريق العودة إلى صافي إنسانيته وخالص آدميته.
انطلاقا مما سبق ومن مبدأ حرية الإنسان فإن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يتحمل مسؤولية ولا أن يعبر عن إرادة كشأن بني آدم، فهل تتحمل الآلة الرقمية مسؤولية الخطأ الطبي حالة وقوعه؟ وهل سيتدخل القانون لعقابها وجزائها؟ وحتى لو فُرِض وقوع هذا العقاب فما الجدوى منه؟ وهل ستبقى للقانون سلطة أو قيمة أو حكمة في مستقبل عالم تحكمه الرقميات؟
وبالنسبة للتعبير عن الإرادة فالإنسان يأكل الطعام خضوعا لحاجة غريزية، كما أن الآلة تشحن بالطاقة خضوعا لحاجة مادية، لكن هل تستطيع هذه الآلة اتخاذ قرار الصيام ليوم واحد، فضلا عن إدراكها معانيه ومدلولاته ومقاصده.
الإنسان وحده هو القادر على اتخاذ هذا القرار، لأن الصيام هو أسمى تعبير عن الإرادة، كما أنه أرقى إشارة إلى الحرية.
وبالنظر إلى سؤال الفن الذي يميز الإنسان عن سائر المخلوقات بل المصنوعات كالآلة الرقمية فقد يعترض معترض مقدما دعوى معاصرة مفادها قدرة بعض الأنظمة الحاسوبية على كتابة الرواية أو تأليف بعض المقاطع التي ظنوها فنية لوقوعهم في غيبوبة الانبهار بسبب الفعل الرقمي في الزمن الراهن، والجواب هو الآتي:
إن الرواية المعاصرة قد تخلت عن عمقها الفني الذي كان يعبر عن روح الإنسان، ذلك أنها تأثرت أشد التأثر بالمنهج العلمي في التحليل والتجريب، وما دامت كذلك فإن الحاسوب بفعل ما سموه ذكاء يكون أعم إحاطة بهذا المنهج، ومن ثمة لن تستعصي عليه كتابة رواية علمية أكثر منها فنية.
إن مُلاحظ شخصيات الرواية المعاصرة سيكتشف بناء على ما ذكرت في النقطة الأولى أنها انحدرت من مستوى الشخصية ذات الفرادة والطبيعة البشرية إلى مستوى الشيء والمادة، ومعلوم أنها إذا خلت من الوجدان أصبحت مظهرا لا يستعصي على فعل الآلة الإجرائي بناؤه وإنشاؤه.
إن العلاقات القائمة بين الشخصيات في الرواية المعاصرة علاقات آلية تغيّب كل المشاعر الوجدانية وتحضر مجموعة من الأنشطة والإجراءات التحليلية حتى تصبح تلك العلاقات في أمتن أحوالها علاقة سبب بنتيجة، ومعلوم أنه لا علاقة أنسب للتحليل العلمي من هذه العلاقة التي يتقنها الحاسوب أيما إتقان.
إن النقد الذي تناول الرواية المعاصرة هو نقد معجب في أغلبه بالمناهج العلمية التحليلية، وبذلك وقع في تمجيد هذه الرواية التي اتخذت لها معايير تنأى عن المعايير الفنية الأدبية التي يجب أن تكون في الأصل هي الحكم في التقويم.
ولذلك وجدنا كثيرا من النقاد يعتمدون نظريات علمية محضة تتعلق بالفيزياء وجراحة الأعصاب وغيرها، فيخرجونها عن مجالها ويسقطونها على مجال بعيد كل البعد عن الأول، فكأنهم يريدون أن يتعاملوا بقانون الجسد مع الروح أو بمقاييس المادة مع المعاني، وهذا خلل في المنهج كبير لو كانوا يعلمون.
هذا فضلا عما فيه من شطط نتيجة محق الاختلاف بين المعارف واستتباع أغلبها القانون العلمي التجريبي والمادي دون اعتراف بالاعتبار المعنوي لكل معرفة.
وفي الختام، يبقى السؤال موضوعا حول قدرة الإنسان على إنقاذ نفسه من سابق تعاقده مع الزمن الرقمي ما دام هذا التعاقد في طوره الضمني وقبل أن يقفز إلى طوره الرسمي، فيُستعبَد الإنسان أسوأَ مما استُعبِده في الزمن الغابر، فيضيع منه وجوده وتاريخه كما أصبحت تضيع منه ثقافته وكينونته، خاصة مع ظهور تقنية تصرف الإنسان عن حضوره الواقعي وواقعه الحضاري، ليصبح مواطنا أو “أفاتارا” داخل مدينة الإنترنت التي تلغي بُعد العالم الحقيقي مدخلة الإنسان في متاهات الماوراء وغيبوباته حتى تغرقه في مزيد من الوهم والتيه بعيدا عن سؤال المعنى والقيم.
وما عليه حينها إلا أن ينتظر – إن سُمح له بالوجود- إنهاء الزمن الرقمي دورته بكل عُجَرِها وبُجَرِها، ثم يلملم نفسه ليستأنف دورة جديدة لا ندري بما هي آتية.





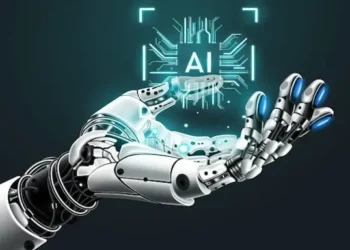



![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](https://shaabjo.com/wp-content/uploads/2026/01/Picsart_26-01-25_21-29-04-328-350x250.jpg?v=1769366871)
